يقول ربنا سبحانه وتعالى : ﴿وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ [البقرة : 14]. وبالبحث في اللغة نجد أن "خلا" ترتبط بحرف (الباء) وليس (إلى)، وفي الحديث (لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة) [رواه مسلم] وهو في كلام العرب وشِعرهم قد استقر على ذلك. فكأن أصل القول هو: "وإذا خلو بشياطينهم"،. فماذا عن (خلوا إلى)؟ هناك فهم أعمق للخلو. ولو لم أكن أعرف إزاءها قاعدة التضمين (تضمين فعل آخر يعبر عنه حرف) لم أكن لأصل إلى هذا المعنى العميق الذي يصور حالة نفسية من العناد، حالة من النية المبيّتة، من استقرار النفاق في قلوبهم باعتباره أمراً مطمأنًا إليه لا رجعة فيه. هذا يعطيني أحكامًا وتصورات أخرى غير تلك المفهومة من مجرد أن أحدهم خلا بآخر. وكل ذلك في كلمة واحدة، بل في حرف واحد هو (إلى).
ومن التعلق في التركيب أيضاً نجد (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ حيث نجد حرف (الباء)، ونعتقد تلقائيًا أن هذا الحرف سيكون متعلقاً بفعل، فأين الفعل هنا؟ غير موجود! إذن لابد أن أقدَّره أي أتخيله. ويأتي هنا نوع من أنواع الوعي والفهم العميق للمناسبة التي لابد فيها أن أقدّر شيئاً غير موجود أمامي، وهذا ما يسمونه (الإضمار). وما الذي يكشف لي ذلك ويدفعني إليه؟ إنها القاعدة التي ذكرناها: إنه لابد لكل حرف في اللغة العربية أن يتعلق بفعل. فأين الفعل؟ ما المناسب؟
يمكن أن يكون التقدير عامًّا غير محدد المجال: نبدأ أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكن أن يكون تقديرًا خاصًّا محدد المجال: أقرأ أو تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
وقد يكون التقدير بالفعل "أبدأ، أقرأ..."، أو بما يقوم مقام الفعل كالمصدر مثلاً: ابتدائي أو قراءتي باسم الله. وقد يكون المقدَّر مقدماً: "ابدأ باسم Q"، أو يكون مؤخراً: "باسم Q أبدأ". ثمانية احتمالات. وهذه الاحتمالات الثمانية أتخير منها الأرجح والأنسب.
إذن الحروف لها قصة كبيرة أخرى. إننا ينبغي ألا نقف فقط عند أثر الحرف، و لا حتى عند وظيفته، بل ينبغي أيضاً أن نبحث في سائر قضايا اللفظ: قضايا الاشتقاق، وقضايا الاشتراك، وقضايا الحقيقة والمجاز، بل نبحث أيضاً في الجملة: التركيب والسياق والسباق
واللحاق وغيرها. وما هذا الاستعراض إلا محاولة لاستفزاز العقل المعاصر لارتياد هذه الرحلة الضرورية
أول أحوال اللفظ "الاشتقاق":
عندما جمعنا الكلام العربي وجدناه غالباً ما يتكون من ثلاثة حروف. بالطبع وجدنا بعضاً من الكلمات التي تتكون من حرفين ومن حرف مثل الحروف (و، أو)، لكن الكلمة في الأغلب أصلها ثلاثة حروف. ووجدنا عندنا ثمانية وعشرون حرفاً نريد أن نكوّن منها كلمات من ثلاثيات؛ (أي كل كلمة ثلاثة حروف)، فإنه بالتباديل والتوافيق يظهر لدينا نحو خمسمائة مليون احتمال لكلمات, هذا في إمكانية أن أكّون ثلاثيات. لكن ما ورد إلينا من لسان العرب لا يزيد عن ثمانين ألف جذر لغوي، والباقي مهمل.. فالذي استعمله العرب من المتاح أقل بكثير جداً من الذي أهملوه، كأن المستعمل نحو اثنين في الألف (0.2%) من المتاح.
هذه الثمانون ألف جذر تكون ما يقرب من مليوني كلمة إلا قليلاً. فالجذر هو الثلاثي (أَكَلَ) والكلمة هي الجذر ومشتقاته: (آكل، آكل، مأكول، أكلة، مأكلة...الخ).
وعندما نقارن العربية باللغة الإنجليزية -باكسفورد مثلاً- نجد أن الكلمات التي تقابل ما عندنا نحو (860) ألف كلمة غير الذي دخل في الإنجليزية من الجرمانية والعربية واللاتينية وغيرها، هذا في اكسفورد الكبير (الذي يبلغ نحو خمسة وعشرين مجلداً). الكلمات في وبستر لا تزيد عن مائة ألف كلمة ( كلمة لا جذر)،و الكلمات في (مايكل ويست) نحو أربعة وعشرين ألفًا. أما في اللغة العربية فلدينا: ثمانون ألف جذر في لسان العرب لابن منظور، وهو أكبر موسوعة موجودة في هذا الباب. منها ثلاثون ألف جذر، في المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية في مصر. وأربعون ألفاً في القاموس المحيط للفيروزآبادي.
كم جذر من هذه الجذور يشتمل عليها القرآن الكريم؟ يحوي القرآن (1840) جذرًا؛ أي أقل من2.5 ٪ من الجذور المستعملة في اللغة. وهذا ينبئ أن الأمر سهل شيئاً ما، لأنني لو أتيت بهذه الجذور الــ(1840) وتعاملت معها بهذا العمق، فسوف أتمكن من فهم القرآن بعمق أكثر، وأتمكن –مع بعض قواعد المستويات المختلفة للفهم- أي أن أفهم فهماً آخر.
ومن ناحية أخرى، فإنه بعد الجذر تأتي الفروع، والفروع تسمى المشتقات، والتفريع يسمى الاشتقاق، وهذا الاشتقاق يتم على قواعد وأوزان فيما يسمى بالصرف أو التصريف. وهذه الأوزان لها معانٍ ودلالات عامة في كل الكلام. فالوزن يمكن أن يستعمل لقضية أو معانٍ معينة مثل: ما كان على وزن "فعْلَلَة" له علاقة بالصوت: صلصلة، سَلْسلة، بلَبلة، جلجلة...الخ، وما كان على وزن "تفاعَلَ" يعبر عن علاقة بين طرفين، مثل: تبايع، تشاجَر، تقاتَلَ...الخ.

 English
English France
France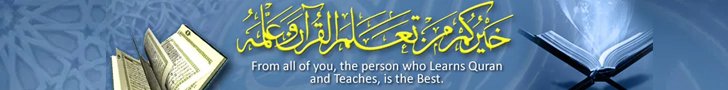
أسئلة الزائرين