تُعد شخصية المفتي من حيث شروطه وآدابه هي المحطة الأخيرة في طريق التشريع الإسلامي، فللإفتاء مكانة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا المنصب في حياته، باعتبار التبليغ عن الله، وقد تولى هذه المكانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم، فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، في أداء وظيفة البيان، وشَبَّه «القرافي» المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالى، وهذه الدرجة العالية للإفتاء ينبغي ألا تدفع الناس للإقبال عليه، والإسراع في ادعاء القدرة عليه، سواء أكان ذلك بحسن نية وهي تحصيل الثواب والفضل، أم بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط والافتخار بين الناس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» (أخرجه الدارمي في سننه)..
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها» (متفق عليه).
أما عن الشروط الواجب توافرها في شخصية من يتولى منصب الإفتاء فهي عديدة، أولها الإسلام، فلا تصح فتيا غير المسلمين للمسلمين. وثانيها العقل، فلا تصح فتيا المجنون. وثالثها البلوغ، وهو أن يبلغ من يفتي الحلم من الرجال، والمحيض من النساء، أو يبلغ ١٥ عاماً أيهما أقرب، لأنه لا تصح فتيا الصغير والصغيرة، والشرط الرابع هو العلم، فالإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر.
ويضاف إلى ما سبق شرط التخصص، وهو شرط نضيفه في هذا العصر، نظراً لطبيعته، ونعني به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دُربة في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص، وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضيان التخصص، ولكن طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذكر، ولقد اعتبرت التخصص شرطاً منفصلاً رغم اندراجه في شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضى التي تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص في علم الفقه والأصول، ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية ولا أصولها. (راجع «البحر المحيط» للزركشي، ج٨ ص٣٦٢).
وهناك شرط الاجتهاد، وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهداً ملاحظاً قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد. يضاف إلى ذلك شرط جودة القريحة: ومعنى ذلك أن يكون كثير الإصابة، صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يتخيل المسائل بقدر ما يعلو اجتهاده، ويفوق أقرانه، فهو يشبه ما يعرف في دراسات علم النفس بالتصور المبدع. والشرط الأخير هو الفطانة والتيقظ، فيشترط في المفتي أن يكون فطناً متيقظاً ومنتبهاً بعيداً عن الغفلة.
وهناك بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها المفتي مثل أن يراعي ألا يفتي حال انشغال قلبه بشدة غضب أو فرح أو جوع أو عطش أو إرهاق أو تغير خُلُق، أو كان في حال نعاس، أو مرض شديد، أو حر مزعج، أو برد مؤلم، أو مدافعة الأخبثين، ونحو ذلك من الحاجات التي تمنع صحة الفكر واستقامة الحُكم، كما عليه الحِفاظ على حسن منظره من نظافة وتطهر، ونقاء سريرته باستحضار النية الصالحة عند الفتيا.
إلا أن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي، والتي قد تصل إلى حد الشروط في أيامنا هذه، التيسير على الناس، وإدخالهم في دين الله، وإلقاء الستر عليهم، والعمل على جعل الناس متبعين لقول معتبر في الشرع، فذلك خير لهم من تركهم للدين بالكلية، وإيقاعهم في الفسق، مما يعد صداً عن سبيل الله من حيث لا يشعر العالم، إذن فالمقصد الأساسي الذي يسعى لتحقيقه المفتي هو إحداث آلية شرعية للتعامل مع التراث الفقهي الإسلامي، بحيث لا تخرج عنه ولا تكون عائقاً للمسلم المعاصر، وأن ذلك لا ينبغي الإنكار عليه لأن الرأي الذي سينتهي إليه محل خلاف، وأساس هذا قاعدة: من ابتلى بشيء مما اختُلِف فيه فليقلد من أجاز.
والتيسير الذي نقصده وتتبع الرخص بشروطه هو ما نقل تعريفه ابن أمير الحاج حيث قال: «أي أخذه من كل منها - أي المذاهب - ما هو الأهون فيما يقع من المسائل (ولا يمنع منه مانع شرعي)»، («التقرير والتحبير شرح التحرير»، لابن أمير الحاج، ج٣ ص٣٥١)، ونستخلص من ذلك أن تتبع الرخص جائز، ولكن بشروط وقيود لا ينبغي إهمالها، وهو مذهب أكثر العلماء، ومن أبرزهم العز بن عبد السلام، والقرافي، والعطار، وغيرهم من المحققين.
وجاء في ذلك المعنى نقول أخرى منها قول سفيان الثوري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره فلا تنهه» («حلية الأولياء» ج٦ ص٣٦٨).
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ويشتد عليهم» («الآداب الشرعية» لابن مفلح ج١ ص١٦٦، و«غذاء الألباب» للسفاريني ج١ ص٢٢٣) .
وقال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي: «وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة» («المغنى» لابن قدامة، ج١ ص١).
إن التيسير على الناس والترخص لهم لإدخالهم في الدين خير من التعسير عليهم وإلزامهم بالقول الشديد، لما في ذلك من مخالفة لمنهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسبيل الصالحين من أسلافنا العلماء، ولما فيه أحياناً من صَـدٍ عن سبيل الله سبحانه وتعالى.. رزقنا الله الفهم والإخلاص.

 English
English France
France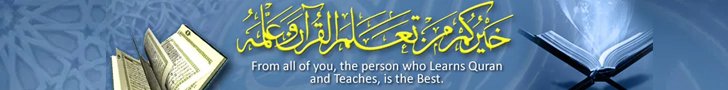
أسئلة الزائرين